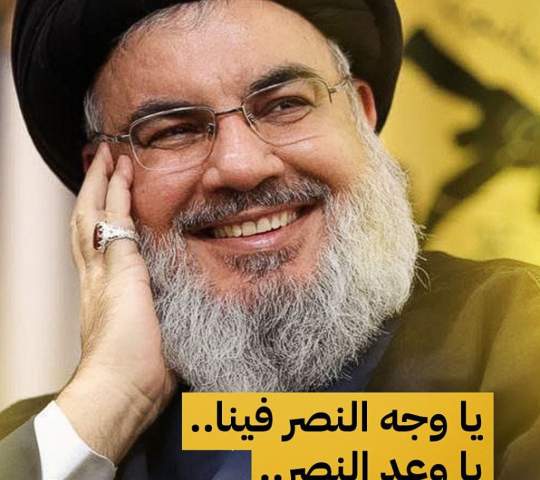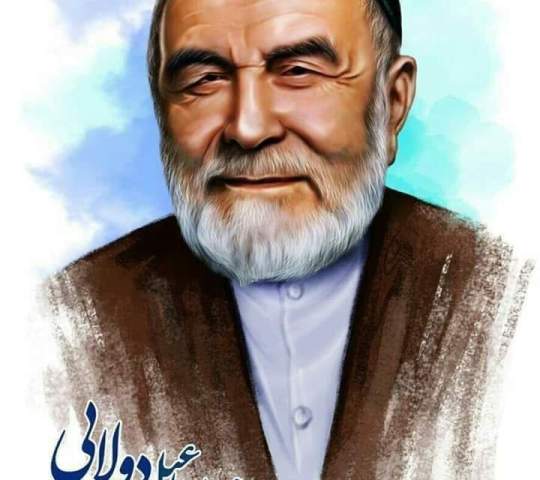مقالات
الكتابة فعل وجودي على رماد الحرب، فاتن مرتضى
د. طراد حمادة في رواية "سرديّة الحرب الكبرى": الكتابة فعل وجودي على رماد الحرب
فاتن مرتضى
هل يمكن للكلمات أن تقاوم الرصاص؟ وهل باستطاعة الكتابة أن تصبح ملاذًا من خراب العالم ؟
يُعدّ كتاب "سردية الحرب الكبرى" للدكتور طراد حمادة الصادر عن دار البلاغة ٢٠٢٥ ، تتويجًا لمسيرته الفكرية والأدبية، ونقطة تحوّل مفصلية في الأدب الحديث. فالعمل ليس مجرد رواية بالمعنى التقليدي، بل هو "سردية سيرية" تتشابك فيها السيرة الذاتية للمؤلف مع تأريخ الحرب، والتحليل الفلسفي، والسياسي، والاجتماعي، والديني، كل ذلك في نسيج لغوي رفيع يلامس حدود الشعر. تكمن أهمية هذا العمل في تقديمه نموذجًا جديدًا للرواية العربية التي لا تكتفي بسرد الأحداث، بل تتأملها وتفككها فلسفيًا، مقدمًا بذلك شهادة أدبية عميقة على زمن الحروب المتتالية في المنطقة.
المحور السياسي: الحرب كامتحان للسيادة والمقاومة :
لا يقف كتاب "سردية الحرب الكبرى" عند حدوده الأدبية أو التأملية فحسب، بل ينفتح على البعد السياسي بوصفه جوهرًا مكوِّنًا للحرب نفسها. فالحرب، في رؤية د .حمادة، ليست مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل "امتحان للسيادة، واختبار لقدرة الشعوب على أن تكون أو لا تكون". يقدّم الكاتب العدو لا كخصم عسكري وحسب، بل كـ مشروع سياسي استيطاني يسعى إلى نفي الآخر وإلغاء وجوده، مما يجعل المقاومة خيارًا سياسيًا قبل أن تكون فعلًا عسكريًا.
المحور الاجتماعي: آثار النزوح والغربة والأحزان :
لا تقتصر الرواية على وصف الأحداث العسكرية، بل تتطرق إلى الأثر الاجتماعي المدمر للحرب على نسيج المجتمعات، من "أزمنة القتل الجماعي" إلى "حشود التشييع". كما تُبرز الرواية بوضوح البعد النفسي والاجتماعي للغربة والنزوح، خاصة "غربتي الغربية في أسفار النزوح والأحزان في البلاد البعيدة". هذه الغربة ليست مجرد ابتعاد جغرافي، بل هي حالة نفسية عميقة من "منازل الآلام".
المحور الفلسفي: نقد الحرب كفعل وجودي:
لا يكتفي د. حمادة بإدانة الحرب ووحشيتها، بل يتجاوز ذلك إلى النقد الفلسفي للتأمل في دوافع الصراعات البشرية وأسبابها العميقة. فهو لا يكتفي بإدانة "أزمنة القتل الجماعي"، بل يتساءل عن العوامل الوجودية التي تدفع البشر إلى الدمار، مما يرفع العمل من مجرد رواية إلى نص فلسفي عميق.
• الحرب كوجود كوني وفلسفة التاريخ : يرى الكاتب أن الحروب المعاصرة ليست منفصلة عن سياقها التاريخي، بل هي جزء من "حرب وجودية كونية"، وهو ما يتأكد من إشارة المؤلف إلى رحلته الفكرية إلى "أكاديمية أفلاطون".
• فلسفة الذاكرة والنسيان : تتجلى الذاكرة كخيط أساسي في الرواية، وهي محملة بثقل نفسي هائل. الكاتب محاط بالحروب ولكنه "لا يستطيع الهروب من الماضي". هناك صراع داخلي بين واجب التذكر وثقل الذاكرة المؤلمة، مما يجعل الرواية عملية شفاء نفسي.
محاور أخرى في الرواية
• الكتابة كفعل مقاوم : يستهل المؤلف الرواية بوصف مشاعره المتوترة وأصابعه التي "ساخنة ومرتعشة، لكنها تثبت ولا تتعب حين أكتب". هذا الافتتاح هو تأكيد على أن فعل الكتابة ذاته هو فعل وجودي وضرورة ملحة، ووسيلة لتسجيل "صورة الشهادة الكبرى" وتحويل الألم إلى معنى والذاكرة إلى حقيقة خالدة.
• البعد الديني والروحي : يُنظر إلى الحرب في "السردية" كاختبار للإيمان واليقين. يستحضر النص البعد الديني كطاقة روحية تسند المقاوم في لحظات الخوف والموت، ويُظهر كيف تتحوّل المعتقدات إلى قوة فعلية، حيث "ما من رصاصة تُطلق إلا وتحمل معها يقينًا بأن الموت باب إلى حياة أوسع".
الأسلوب الفني والرموز
يجمع أسلوب د. حمادة بين البلاغة الأدبية والصرامة الفكرية. فهو يستخدم لغة مشحونة بالصور والرموز، لكن دون أن يفقد وضوح الطرح السياسي والفلسفي، كما يكتب: "الكتابة عن الحرب ليست تدوينًا للحطام، بل رسمًا للمعنى في رماد المعركة."
• البنية السردية المبتكرة: يمزج الكاتب السيرة الذاتية مع التأمل الفلسفي والتاريخي، مما يكسر البنية الروائية التقليدية ويخلق نصًا هجينًا يصعب تصنيفه.
• الدلالات الزمنية: يُلاحظ أن الكاتب يولي أهمية كبرى للزمن. فـ "تعداد الليالي والأيام والساعات والأوقات" ليس مجرد تفصيل، بل هو تأكيد على أن الزمن نفسه يصبح كيانًا ماديًا ومقياسًا للألم والغربة.
• الأسلوب الشاعري والتناص: تتميز الرواية بأسلوب شاعري يظهر في اللغة المجازية والإيحائية، واستخدام الصور البلاغية مثل "الأزمنة المطوية". كما أنها غنية بـ التناص الثقافي والتاريخي، أي تضمين نصوص وأفكار من حضارات أخرى.
• الرموز العميقة: تُوظف الرواية رموزًا عميقة تمنحها أبعادًا إضافية، مثل:
• اللوح المحفوظ: يرمز إلى الذاكرة الكونية والتاريخ المقدس.
• حصان طروادة وكأس جمشيد: تدل على امتداد الصراع عبر الحضارات.
• "فلسطين كسجن كبير": يختصر معاناة شعب بأكمله.
• ضاحية العشق والمجد: تمثل الفضاء الذي يتجاوز الألم، وهي رمز للمقاومة والأمل.
الخاتمة
في نهاية المطاف، "سردية الحرب الكبرى" للد.طراد حمادة ليست مجرد رواية، بل هي شهادة أدبية عميقة على زمن الحروب المتتالية في المنطقة. إنها نص رياديٌ يجمع بين بلاغة الأدب وعمق الفكر وصدق التجربة، ويعيد رسم صورة الحرب من الداخل، لا كحدث عابر في الزمن، بل كسردية كبرى تعكس صراع الإنسان من أجل الحرية والكرامة والوجود. بهذا، ترسخ الرواية نفسها كعمل أدبي وفكري ذي أهمية بالغة في المشهد الثقافي المعاصر، وتؤكد أن الكتابة هي فعل مقاومة خالد. وفي ضوء هذا الإرث، يبقى التساؤل: كيف يمكن لهذه السرديات الوجودية أن تواصل رسم ملامح الوعي الجمعي في مواجهة حروب المستقبل المجهولة؟
كاتبة وناقدة لبنانية